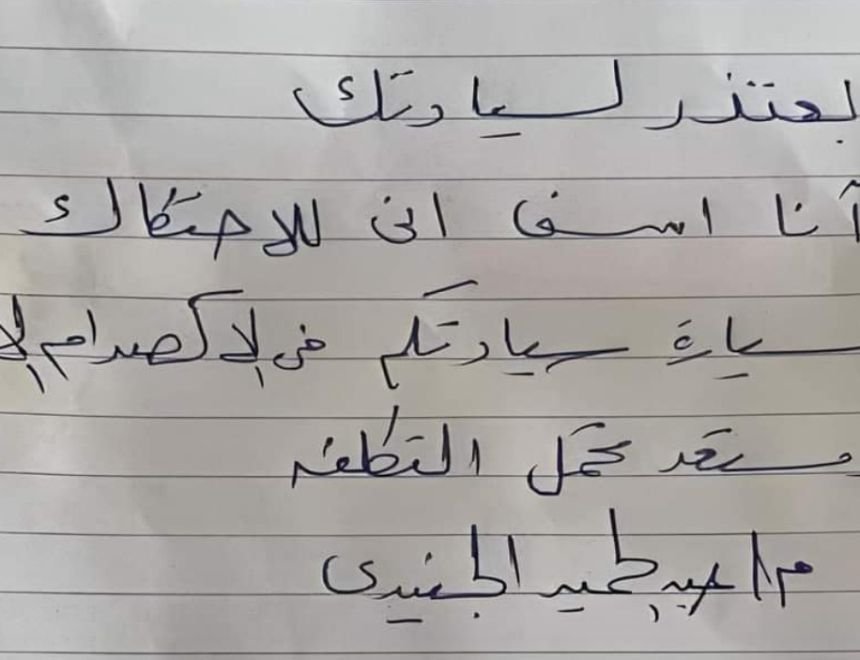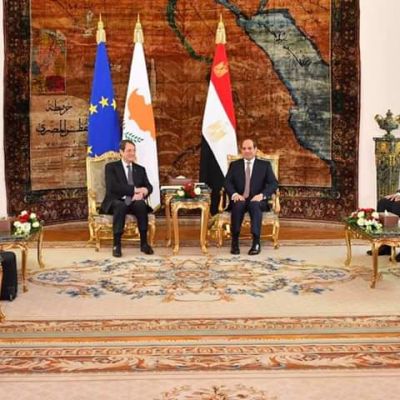كلما تجدد علينا العام الهجري هيَّج في نفوسنا المعاني العظيمةَ التي تحملها كلمة الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، لأنها حدَثٌ لا كالأحداث، وهجرةٌ لا كالهجر الشخصية لمآرب ذاتية.
إنها هجرةٌ عن قوم عَميت أبصارُهم، وأظلمت قلوبُهم، وصُمَّت آذانُهم فلم يروا النور المحمدي، ولم يفقهوا التنزيل الحكيم، ولم يسمعوا كلام الله تعالى سماع قبول وتدبر، فهم صمٌّ بكمٌ عميٌ لا يبصرون، فكيف يعيش ذو النور المبين، والهدى المستقيم مع قوم عطلوا حواسهم التي تميزوا بها، وأصبحوا كالأنعام.
إنها هجرةٌ لحماية النفس التي تحمل الرسالة الإلهية للبشرية التي أريد إزهاقها بتمالؤٍ بغيض، ودلالة شيطانية خسيسة لإطفاء نور الله تعالى الذي أنزله لعباده لإرجاعهم إلى الفطرة التي خلقها فيهم، وإلى الحنيفية التي شرعها لهم، وإلى الكرامة الإنسانية التي كتبها المولى جل شأنه للإنسان.
إنها هجرةٌ إرشادية للبشرية بأن أرض الله واسعة، فمن هجر بلده فسيجد في الأرض مُراغماً كثيراً وسَعة، ومن اضطر لترك ماله وأهله وولده فسيبدله الله خيراً منه، ما دام أنه أراد الله والدار الآخرة، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
إنها هجرة تُعَلِّم الناس الأخذ بالأسباب العادية التي تُربَط بها المسببات، وأن لا يطلب الإنسان خرق العادات قبل أن يتخذ الأسباب التي أمر الله تعالى عباده بها، حتى يكون جاداً في طلب النتيجة التي يسعى إليها.
هذه الهجرة النبوية التي غيرت مجرى الأحداث، وكانت سبباً لإنارة الكون برسالة الإسلام وهداية الأنام، حيث كانت السببَ الأول لإقامة الدولة الإسلامية التي شعَّ نورها في الخافقين، ووصلت مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بعد أن تهيَّأت لها مقومات تكوينها من أرض وشعب ونظام وقائد، فما هي إلا بضع سنين حتى أصبحت الفرس والروم في مرمى قوس الدولة الإسلامية، تدعوهم لتمكين الشعوب من سماع كلمة الله تعالى التي أوحى بها إلى عبده وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبدالله، الذي بعثه الله تعالى على حين فَترةٍ من الرسل، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فما عليهم إلا أن يؤمنوا به ويتركوا شأن أتباعهم ليختاروا لأنفسهم ما يرونه صواباً في عقائدهم وتعاملاتهم، بما يُسمى بحرية الاعتقاد، وما هو إلا عِقد من الزمن حتى أصبحت الدولة الإسلامية قوةً عظمى لا تقف في وجهها قوةٌ إلا هُزِمت، فتحقق بذلك وعد الله تعالى.
هذه الهجرة التي يتجدد ذكرها عند بزوغ هلال الشهر المحرم، مع أن معانيها لا تغيب عند المسلم المثقف، وعند القارئ المنصف، إلا أن للتاريخ أثراً في الذكر كما قالوا: الشيء بالشيء يذكر.
يتعين علينا معاشر المسلمين أن نجعل من أحداثها تاريخاً لا يُنسى، وفقهاً لا يُمحى، وعِظةً لا تغيب عنا؛ لأنها هي التي أوصلت إلينا نعمة الله تعالى العظيمة، وهي نعمة الإسلام، وهي التي جعلت لنا كياناً نعتز به، وشريعةً أحيت قلوبَنا وأنارت أبصارنا، فجعلتنا خيرَ أمة أخرجت للناس، وجعلتنا أمة الفضائل والمكارم، وجعلتنا أمةً موحدة لله تعالى رب العالمين عابدةً له، لنكون سعداء في الدنيا والآخرة.
والفضل كله لله تعالى الذي بعث فينا هذا النبيَّ الأُمِّي الذي اختاره من أوسط العرب حسباً ونسباً، وزكَّاه بالأخلاق العظيمة، وحلاَّه بالنور المبين، فكان حَظنا من الأنبياء، ونحن حظه من الأمم، فإذا تجددت ذِكراها تجدد معها التوقير والإعزاز لصاحب الهجرة عليه الصلاة والسلام، الذي ضحّى تلك التضحيات العظيمة من أجل إيصال نور الله إلينا، وأصبحنا نعيش في ظِلِّه وهديه، فنفتخر بهذا الدين، ونزداد محبةً لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام.
اللهم زدنا له تعلقاً وبهديه تمسكاً.