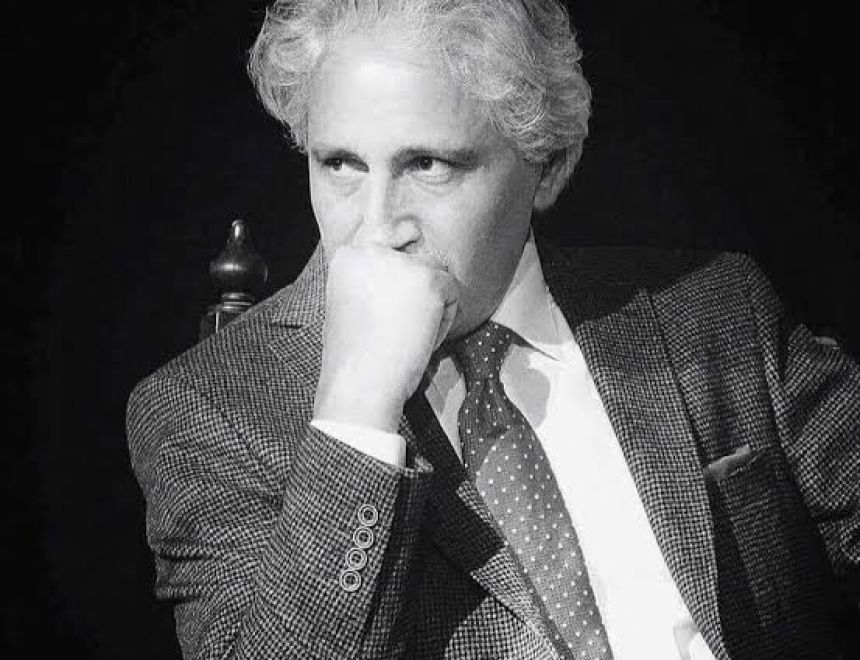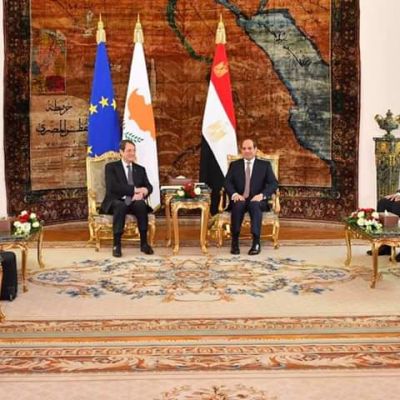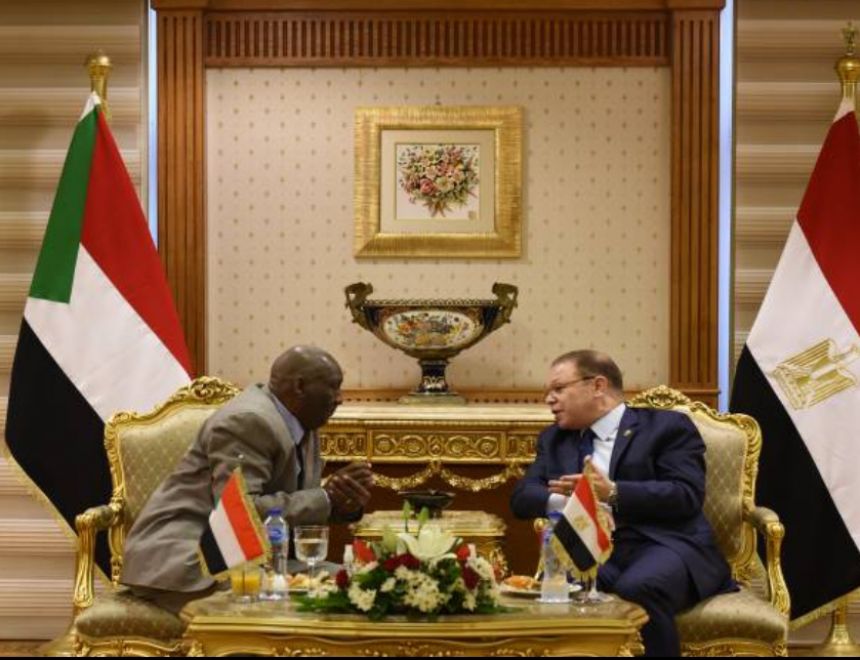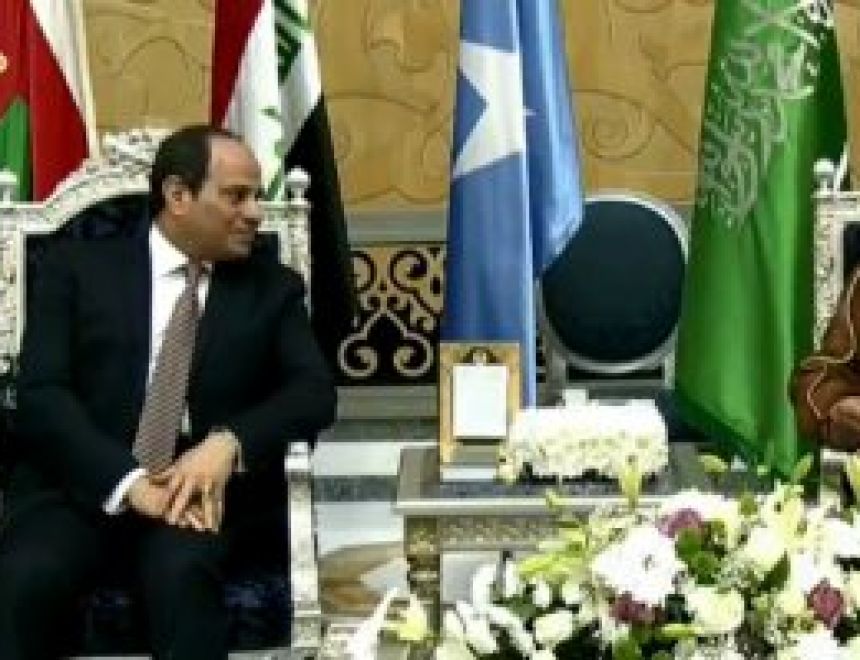نَعيبُ زَمانَنا وَالعَيبُ فينا
وَما لِزَمانِنا عَيبٌ سِوانا
وَنَهجو ذا الزَمانِ بِغَيرِ ذَنبٍ
وَلَو نَطَقَ الزَمانُ لَنا هَجانا
وَلَيسَ الذِئبُ يَأكُلُ لَحمَ ذِئبٍ
وَيَأكُلُ بَعضُنا بَعضاً عَيانا
كلمات للإمام الشافعي بحاجة إلى تأملها وإدراك مراميها التي تجعلنا نستنتج كم أن الحياة والزمان والدهر معانٍ بريئة مما نرميها به من قسوةٍ أو غدرٍ أو ظلمٍ وما إلى ذلك من صفات، يستسهل الكثيرون أن يرموا بها الحياة كلما ضاق بهم أمر، إنها كلماتٌ بمثابة دستور قدري يوضح كيف أن البشر يكونون مصدر العيب وتدني الخلق، فيرمون الدنيا بعيوبهم، فالحياة لا تكذب والحياة لا تخون والحياة لا تغدر والحياة لا تتزلف لمصلحة والحياة لا تتسلق ولا ترائي ولا تنافق، لكنها للأسف كلها سلوكيات مصدرها الإنسان الذي اختار أن يفارق إنسانيته والفطرة السليمة التي فطره الله عليها وهي فطرة الخير، أما الحياة فهي خلق الله البديع التي جعل فيها سبحانه وتعالى الصدق والرحمة والرأفة والاتساق مع النفس وعدم النفاق، كما أوجد سبحانه الصاحب والصديق والأخ ورفيق العمر والدرب، وهي معانٍ بمثابة المنحة الربانية التي وهبها الله لنا لنصونها فُنصان بها، لا لنبدلها بالزيف والخداع.
إن الدين الحنيف لم يغفل أهمية العلاقات الإنسانية التي أوصانا الله ورسوله بها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتماع الناس في خير في حديث سبعة يظلهم الله بظله، يوم لا ظل إلا ظله" منهم رجلان، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي على طاعة الله وصون العهد والكلمة، وتأتي الصداقة كشكل من أشكال العلاقات الإنسانية ذات التأثير الكبير في الإنسان، فالصديق هو الخل، وعلى الرغم من وصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قال "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل"، أي من يصادق قد يتعجل الإنسان بسلام وصفاء نية في اعتبارات ومعانٍ كبيرة حين يصدق أحدهم وهو يؤكد له أنه صديق حميم، وأخ كريم بل شريكٌ في السراء والضراء، ولا نستطيع أبدا أن ننكر أن مثل هذه النماذج الطيبة موجودة في الحياة الرحيمة ذات الألفة، بحيث تدفع بعضها بعضا وتؤازر بعضها بعضا وتتعاون وتتآخى وتتمع على الخير، لكن هناك أيضا من يردد هذه القيم بلسان الفم بينما صوت القلب يضمر ضميرا داكنا وجفوة، كأنه يستخدم هذه المعاني مجرد عبارات أشبه بسلم يصعد به إلى ما يريد ثم يلقي بكل ما قال في سلال المهملات غير معترف بأي من تلك القيم، وكما يقولون شر البلية ما يضحك، كلما أشاهد أداء العاملة في مسرحية "الدخول بالملابس الرسمية" وهي تردد "إنت بابا إنت ماما إنت أنور وجدي"، أضحك دامعا إذ أتذكر موقفًا كهذا لأحدهم أو شخص ما ـ ليس أكثر من ذلك ـ يردد كلمات من جنس أنت أخي أنت صديقي الصدوق، أنت شريك الأيام الصعبة، أنت شريكي في كل شيء لأنك رجل في زمان عز فيه الرجال، لتخفي كل تلك الأقاويل وراءها حقيقة واحدة يكنها القلب وهي بالدارجة "أنت زبون سُقع"، فكأنه بدا ممتنا لمن عاونه في تجاوز محنة، ثم بعد أن احتاجه هذا الذي دعاه صديق ذهبت كل تلك النداءات مع رياح الزيف والتملق والكذب، فقال لمن دعاه يومًا بأخي العزيز: "أنا أتعامل مع زبائني كده .. وأنت زبون" .. فأصبح بين عشية وضحاه التعامل لا يتجاوز هذا المعنى.
ولأن الإنسان يتأثر بمخالطة رفيقه وصديقه، فلابد لنا أن نحسن اختيار أصدقائنا ورفقائنا والصديق الصالح من يصدقك القول والفعل، فالأخ درجة من درجات العلاقات الإنسانية في مرتبة كبيرة بحكم القربى، وهو الشخص الذي يمكنك الاستناد عليه مهما كان ثقل همك ويخبرك كيف تتصرف بالشكل السليم في المواقف الصعبة، والصاحب شريكُ الأيام الصعاب أيضا درجة لا يُستهان بها إذا وعى أطرافها معناها، أما الصديق والأخ فمعنى كبير جدا جدا، يُحمّل أمانة كبرى في عُنق القائلين بها، أمانة تستوجب النصح والصدق وحفظ العهد وأن يكون الصديق دالا على الخير، صادقا في قوله وفعله ومحبته وتقربه.
فمن أسف أن يكون الحرص على الدنيا هذا السبب الواهي سبيلا لأن يخسر الإنسانُ إنسانا أو يخدعه ليصل من خلاله إلى مصلحته الدنيوية، فنجد صداقات تنطفئ عند انتهاء المصالح وفي الوقت نفسه نجد أن هناك أصدقاء مثل الغيث، والعنوان الدائم للصداقة هو الوفاء، فعلموا أنفسكم وأبناءكم هذه المعاني، علموهم عدم الخلط بين المسميات واستغلوا الحياة لكسب إخوة وأصدقاء حقيقيين تجدونهم ويجدونكم في المحنة حتى تصبح منحة، ولن تخلوا الحياة من الشركاء والزبائن فهي أمور طبيعية لكن من المهم أن نتسق مع ذواتنا وألا نخلط الأمور ببعضها البعض وألا نتاجر بالمعاني ونستبدلها في غير مواقعها، أي نكون دائما صادقين مع أنفسنا ومع الآخرين، وأخيرًا يقول الشاعر زهير بن أبي سُلْمى:
إذا كنت في قوم فصاحب خِيارَهم ... ولا تصحب الأردا فترْدى مع الرَّديِ.